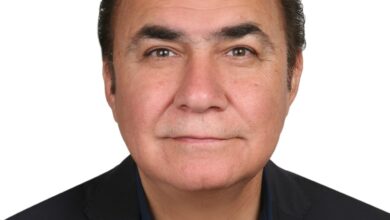العلاقة بين القاهرة وتل أبيب في زمن الحرب: كيف أعادت غزة رسم حدود السلام المصري–الإسرائيلي؟

أبوبكر إبراهيم أوغلو
شكّلت الحرب الدائرة في قطاع غزة أخطر لحظة تمرّ بها العلاقات المصرية–الإسرائيلية منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979. فعلى الرغم من ثبات الإطار القانوني للسلام، فإن السلوك السياسي والميداني لكلا الجانبين خلال الحرب كشف عن توتر عميق، وقلق متبادل، ومحاولات حثيثة للحفاظ على التوازن الدقيق الذي حكم العلاقة طوال عقود.
منذ اليوم الأول للحرب، وجدت القاهرة نفسها أمام مشهد غير مسبوق: عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة على طول محور فيلادلفيا، على بعد أمتار فقط من الحدود المصرية؛ حديث سياسي وإعلامي في إسرائيل عن “خيارات بديلة” قد تشمل تهجير سكان غزة نحو سيناء؛ سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الغزي من معبر رفح؛ وارتفاع أصوات داخل إسرائيل تطالب بإعادة ترتيب الواقع الحدودي وربما إعادة صياغته بالكامل. كل ذلك جعل العلاقة مع تل أبيب تنتقل بسرعة من مستوى الهدوء البراغماتي إلى مستوى “إدارة المخاطر”.
الخط الأحمر الأساسي الذي رسمته القاهرة منذ البداية كان واضحاً: لا تهجير للفلسطينيين إلى سيناء تحت أي ظرف. هذا الموقف لم يكن مجرد تصريح سياسي عابر، بل إعلان واضح بأن الأمن القومي المصري على المحك. وقد شكّل هذا الملف نقطة التوتر الأبرز بين القاهرة وتل أبيب، خصوصاً بعد تداول خطط وتسريبات تتحدث عن إخراج سكان القطاع مؤقتاً أو دائماً إلى الأراضي المصرية. القاهرة فهمت خطورة هذه الطروحات جيداً، ليس فقط باعتبارها تهديداً مباشراً لسيادتها وحدودها، بل لأنها تنقل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي إلى داخل الأراضي المصرية نفسها، وتحوّل سيناء إلى ساحة مواجهة مفتوحة.
ورغم هذه التوترات، حافظت الدولة المصرية على جوهر اتفاقية السلام مع إسرائيل، مع إبقاء القنوات الأمنية والعسكرية مفتوحة، لا سيما في ظل الحاجة إلى تنسيق مستمر لمنع تفلت الحدود أو اندفاع المدنيين باتجاه سيناء. لكن في المقابل، انخفض مستوى التواصل السياسي إلى الحد الأدنى. لم تُعلن أي اتصالات بارزة على مستوى القيادة، وتراجع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وبقيت السفارتان في القاهرة وتل أبيب تعملان دون سفراء كاملين، في إشارة مدروسة إلى أن العلاقة مستمرة لكنها ليست في حالة “طبيعية”.
السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح كانت لحظة مفصلية في علاقة الطرفين. فقد اعتبرتها القاهرة محاولة لتغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ عقود، وخرقاً للتفاهمات غير المكتوبة التي تنظّم إدارة المعبر والوجود الأمني حوله. ورد الفعل المصري جاء عبر مواقف سياسية حادة، وتكثيف للاتصالات مع العواصم الدولية، والتحذير من أي خطوة يمكن أن تفضي إلى إعادة ترسيم الحدود أو إنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي الفلسطينية أو المصرية. كما ساهمت هذه السيطرة في دفع مصر إلى خطوة غير مسبوقة تمثلت في الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، في رسالة دبلوماسية واضحة بأن تجاوزات تل أبيب في غزة بلغت مستوى لا يمكن للقاهرة تجاهله أو استيعابه في إطار “إدارة خلاف داخل بيت السلام”.
وعلى الرغم من هذا التوتر السياسي العميق، ظل الجانب البراغماتي حاضراً في العلاقة بين القاهرة وتل أبيب. فقد واصلت مصر استيراد الغاز من إسرائيل، واستمر العمل باتفاقية “المناطق الصناعية المؤهلة” (QIZ) التي تسمح بتصدير المنتجات النسيجية المصرية إلى الولايات المتحدة بمكوّن إسرائيلي. غير أن استمرار هذه الترتيبات الاقتصادية كان في جوهره تعبيراً عن التزام القاهرة بالاتفاقيات الدولية، أكثر من كونه دليلاً على حالة انسجام سياسي أو ارتياح متبادل في لحظة الحرب.
الحرب كشفت أيضاً عن فجوة واسعة بين موقف الدولة المصرية تجاه إسرائيل ومشاعر الشارع المصري. فقد امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بخطابات غاضبة، وعبّرت شرائح واسعة من الرأي العام عن رفض قاطع لأي شكل من أشكال التطبيع، وظهرت حالات اعتداء فردية على إسرائيليين أو يهود داخل مصر عكست منسوب الاحتقان الكامن. في المقابل، حافظت القيادة المصرية على خطاب مزدوج: إدانة واضحة للعمليات الإسرائيلية في غزة، وتشديد على أن ما يجري “حرب غير إنسانية”، وفي الوقت نفسه التأكيد على أن معاهدة السلام خيار استراتيجي لمصر وأن هدمها ليس مطروحاً على الطاولة.
هذا التوازن بين الرفض والالتزام، بين الغضب الشعبي والدبلوماسية الرسمية، وبين التاريخ السياسي والوقائع الراهنة، هو ما يرسم اليوم ملامح العلاقة بين القاهرة وتل أبيب. فمصر لا تبدو في وارد التخلي عن السلام الذي شكّل منذ أربعة عقود ركيزة لاستقرارها الحدودي وتفرغها لأزماتها الداخلية، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل – ولا يمكن أن تقبل – بأي ترتيبات تمسّ حدودها أو مستقبل غزة أو جوهر القضية الفلسطينية.
من زاوية أخرى، منحت الحرب القاهرة فرصة لإعادة تأكيد موقعها كلاعب إقليمي رئيسي لا يمكن تجاوزه في أي حل يتعلق بغزة أو بالمسار الفلسطيني عموماً. فقد تعاملت القوى الدولية مع مصر بوصفها بوابة العبور الإجباري للمساعدات، ومنصة التفاوض الأساسية في ملفات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والشريك العربي الأثقل وزناً في أي ترتيبات تخص اليوم التالي للحرب. هذا الدور الإقليمي يعيد صياغة علاقة القاهرة بتل أبيب من موقع طرف يراقب المشهد، إلى موقع طرف يملك القدرة على التأثير في حدود حركة إسرائيل وخياراتها في غزة.
في ضوء كل ذلك، يمكن القول إن معركة غزة أعادت رسم خطوط التماس السياسية بين القاهرة وتل أبيب. فالسلام لم يسقط، لكنه دخل مرحلة جديدة أكثر هشاشة وحساسية، والأمن القومي المصري عاد ليتموضع في قلب معادلة العلاقة مع إسرائيل، بينما أصبحت القضية الفلسطينية – وغزة تحديداً – العامل الحاسم الذي يحدد مدى دفء أو برودة هذه العلاقة في السنوات المقبلة.
في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب، تبدو القاهرة أكثر تمسكاً بثلاث حقائق أساسية: أن أمنها القومي يبدأ من حدود غزة، وأن أي تهجير أو إعادة هندسة ديموغرافية للقطاع يمثل خطاً فاصلاً لن تسمح بتجاوزه، وأن مستقبل علاقتها مع تل أبيب لا يمكن فصله عن مستقبل القضية الفلسطينية ذاتها، ولا عن إمكان تحقيق تسوية تاريخية عادلة تُنهي الاحتلال وتفتح الباب أمام سلام حقيقي يمتد إلى الشعوب قبل الحكومات.
الاراء المنشورة على مراسلين لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع