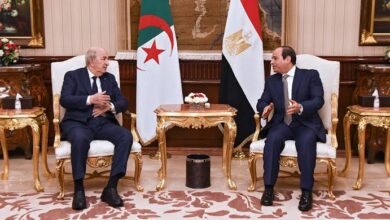أكذوبة السلام الدائم في النظام العالمي..توقعات باستمرار الصراع والعنف المنظّم خدمةً لمصالح الدول الكبرى والمهيمنة

المصدر: موقع جيوﭘوليتكس
ترجمة وتحرير: عصام حريرة
شهد النظام الدولي الحديث استمرار النزاعات المسلحة على مدى قرون، دون أن تخلو أيُّ حقبةٍ زمنية كاملة من الحروب في مختلف الأقاليم؛ إذ تشير قواعد بيانات تاريخية تغطي ما يقرب من 3500 عام إلى أن عدد السنوات التي لم تشهد حروبًا كبرى لم يتجاوز نحو 268 عامًا فقط. وتتسق هذه الأرقام مع دراساتٍ كمية راسخة عن الحرب أنجزها باحثون، أظهرت أبحاثهم الحرب بوصفها ظاهرة بنيوية متكررة لا إخفاقًا عارضًا أو استثنائيًا.
وبالتالي، فإن عدم وجود عقد زمني واحد سلمي بالكامل يطعن في الافتراضات الليبرالية القائلة، إن التكامل الاقتصادي أو نمو المؤسسات كفيلان بخفض العنف المنظم تلقائيًا؛ ففي أواخر القرن العشرين، وهي الحقبة الأكثر هدوءًا نسبيًا، استمرت النزاعات المسلحة في البلقان ووسط أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وتُظهر تحليلات الاقتصاد السياسي أن الحرب تستمر لأن الصراع يظل متجذرًا في الحوافز الاقتصادية والعقائد الأمنية والمصالح المؤسسية؛ فالقطاعات العسكرية–الصناعية لدى القوى الكبرى تعتمد على دورات توريد مستدامة، وميزانيات بحث وتطوير، وأسواق تصدير مرتبطة مباشرة بتهديدات متوقعة أو فعلية. وتبيّن بيانات “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أن الإنفاق العسكري العالمي واصل الارتفاع بعد انتهاء الحرب الباردة، بدلًا من أن ينخفض على وقع انتهاء الحروب. كما ازدادت عمليات نقل الأسلحة خلال فتراتٍ وُصفت علنًا بأنها مراحل “بناء سلام”، بما يدل على أن النظام العالمي ما زال مستمرًا بين خطاب إدارة الصراع والاستعداد المادي للحرب.
في السياق ذاته، تفسّر نظرية تشكّل الدولة استمرار الصراع من خلال التنافس على السيادة والحدود والشرعية الداخلية؛ فقد وصف “تشارلز تيلي” تطور الدولة الأوروبية باعتبار أن صنع الحرب وصنع الدولة عمليتان متلازمتان وتعزِّز إحداهما الأخرى، وليستا متعارضتين. وغالبًا ما ورثت الدول ما بعد الاستعمار حدودًا اعتباطية وقدراتٍ مالية ضعيفة وسلطاتٍ مجزأة، وهي ظروف ترتبط بقوة بتكرار العنف الداخلي. كما إن التهميش الاقتصادي، واستخراج الموارد، وضغوط الديون الخارجية، كل هذا يقلّص مناعة الدولة في مواجهة التمرد والصراعات الفصائلية.
من جهة أخرى، يشير التاريخ إلى أن سنوات السلام تحققت أساسًا خلال فترات الهيمنة الإمبراطورية، وليس في ظل كبحٍ متوازن متعدد الأقطاب؛ فقد مثّل “السلام الروماني” و”السلام البريطاني” نظاميْ ضبطٍ قسري قائمين على إسقاط قوةٍ ساحقة، لا على مساواةٍ دولية تفاوضية أو كونية قانونية. وقد جرى في ظل هذه الأنظمة إزاحة العنف جغرافيًا مع الإبقاء على الإكراه داخل أطراف الإمبراطوريات، وعلى طرق التجارة، وفي الأقاليم الاستعمارية، وهكذا انخفضت النزاعات بين قوى المركز لكن جرى تصدير عدم الاستقرار إلى المناطق التابعة.
وقد نشأت المؤسسات الدولية الحديثة عقب حروبٍ طاحنة واسعة النطاق، لا بوصفها أدواتٍ حالت دون اندلاعها مسبقًا؛ حيث تأسست “عصبة الأمم” بعد الحرب العالمية الأولى، ثم انهارت في ظل اختلالاتٍ في موازين القوة وانهيارات اقتصادية. أما “الأمم المتحدة”، التي تشكّلت بعد الحرب العالمية الثانية، فقد ضمنت حق النقض للقوى الكبرى بما كرّس الهرمية بدلًا من إزالة التنافس القسري، وتُظهر حالات الشلل في مجلس الأمن أثناء النزاعات الكبرى حدود الفاعلية المؤسسية، عندما تتباين المصالح الجوهرية للأعضاء الدائمين.
من الناحية الاقتصاية كذلك، ترتبط الدورات الاقتصادية بتواتر النزاعات وحدّتها وفق تحليلاتٍ تاريخية طويلة الأمد؛ إذ تتزامن فترات أزمات الديون وصدمات أسعار السلع والانكماش المالي، مع تصاعد الاضطرابات الداخلية والتوترات بين الدول. وتبيّن أبحاث “جاك ليفي” وجود روابط قوية بين مراحل انتقال القوة واندلاع الحروب الكبرى؛ فالقوى الصاعدة أو الآفلة تواجه حوافز لاختبار مواقعها أو الدفاع عنها بوسائل قسرية عندما يبدو التكيّف السلمي غير مرجّح.
ولم تُفلح التغيرات التكنولوجية في تقليص الحروب، رغم الادعاءات المتكررة بأن القدرة التدميرية تُنتج ردعًا دائمًا؛ فقد قيّدت الأسلحة النووية الصراع المباشر بين القوى العظمى، لكنها كثّفت الحروب بالوكالة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما أدّى انتشار الأسلحة التقليدية لزيادة ضراوة النزاعات المحلية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، حتى في الفترات التي تراجع فيها مؤقتًا عدد الحروب بين الدول. وفي العصر الحديث، وسّعت الحروب السيبرانية والاقتصادية مجالات الصراع دون أن تحلّ محل العنف الحركي، بل أضافت طبقاتٍ جديدة من المواجهة.
ومن هنا، فإن الادعاء بأن المجتمعات الحديثة تتجه نحو سلامٍ دائم يعتمد بقوة على مقاييس انتقائية وأطرٍ زمنية ضيقة؛ فقد تعرّضت أطروحة “ستيفن بينكر” حول “تراجع العنف” لانتقاداتٍ من مؤرخين وباحثين في النزاعات، بسبب تقليلها من احتساب الوفيات غير المباشرة للحروب وأشكال الإكراه. وتُظهر سجلات “برنامج أوبسالا لبيانات النزاعات” استمرار مستويات العنف المنظم منذ منتصف القرن العشرين، رغم تذبذب أعداد القتلى في ساحات القتال. فقد حلّت الحروب الأهلية والتدخلات الخارجية والتمردات العابرة للحدود محل الحروب التقليدية بين الدول، دون أن تُنهي العنف المنظم.
وفي هذا الإطار، فإن الهيكل السياسي–الاقتصادي للنظام العالمي يهدي الاستقرار لصالح الفاعلين المهيمنين، بينما يتساهل مع صراعاتٍ مزمنة في أماكن أخرى؛ فكثيرًا ما تفرض المؤسسات المالية الدولية إجراءات تقشف تُضعف التماسك الاجتماعي وتزيد من الاضطرابات داخل الدول المدينة. كما تُفضّل اتفاقيات استخراج الموارد الشركات متعددة الجنسيات، وتترك الدول المضيفة عرضةً للتنازع المسلح على الريع والسيطرة، وهو ما يزيد من النزاعات الداخلية ويساعد على استمرارها.
وعليه، فإن التاريخ المدوَّن لا يعكس حتميةً بشرية بقدر ما يعكس استمرارًا مؤسسيًا، تشكّله الحوافز واختلالات القوة والبنى الاقتصادية. ويبدو السلام استثناءً ينتج من خلال الهيمنة أو الإنهاك أو التوافق المؤقت للمصالح، دون أن يكون تطورًا أخلاقيًا أو خطًا قانونيًا. وتظل الفترات الخالية من الحروب الكبرى نادرة، لأن الآليات المُولِّدة للصراع تبقى مغروسة في صميم الاقتصاد السياسي العالمي.
وما زالت الشروط البنيوية المنتجة للحرب فاعلة عبر عصورٍ أيديولوجية مختلفة ومراحل تكنولوجية متباينة. لذلك، مما يوصى به في هذا المقام إعادة النظر في حوافز إنتاج السلاح، وإعادة هيكلة أنظمة الديون، ومعالجة آليات حوكمة الموارد غير المتكافئة؛ فخفض النزاعات على المدى الطويل يتطلب تغيير المصالح المادية التي تستفيد من عدم الاستقرار، بدلًا من الاتكال على التزاماتٍ خطابية بالسلام.