غموض وضغط وتهديد.. جوهر السياسة الاستراتيجية لواشنطن وأوروبا تجاه طهران

بقلم: علي زم
تستند السياسة الاستراتيجية المشتركة بين واشنطن وأوروبا حيال إيران إلى مفهوم يقوم على فرض معادلة “التفاوض (الاتفاق) أو الحرب”. وتعتمد هذه المقاربة على مسارين رئيسيين: الضغط الخارجي وإثارة الانقسامات الداخلية، بهدف خلق حالة من الارتباك والتسرع في عملية اتخاذ القرار داخل طهران.
وفي مقال ترجمه ميدل ايست نيوز للكاتب والصحفي الإيراني جلال خوش جهره، جاء أنه في النموذج الجديد لهذه السياسة، لم تعد هناك أدوار تقليدية مثل “طرف جيد وطرف سيئ” التي كانت تُقسم سابقاً بين الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، بل أصبحت المطالب الغربية تُطرح اليوم في إطار توافق واضح ومعلن.
خيار طهران واضح هو الآخر: إما القبول بالمطالب الغربية المتزايدة أو الاستمرار في المقاومة. وتعتمد أدوات السياسة الغربية على ما تعتبره فهماً دقيقاً للوضع الراهن في المنطقة ولأوضاع الجمهورية الإسلامية. هذا الفهم يتقاطع بشكل غير مسبوق مع المصالح الإسرائيلية، وهو ما يجعل طهران أكثر تحفظاً وتردداً في مواصلة محادثاتها مع الغرب.
ويحاول الطرف الغربي، بالتنسيق مع تل أبيب، ترسيخ قناعة بأن هيكل وتوازن القوى في الشرق الأوسط قد تغيّرا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب هذا التصور، فقد تراجع العمق الاستراتيجي لإيران بشكل حاد بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً وتسببت بأضرار في منشآتها النووية، ما جعل طهران، وفقاً للرؤية الغربية، غير قادرة على المقاومة بالمستوى الذي كانت عليه سابقاً. كما يُعتقد أن استمرار العقوبات الاقتصادية سيؤدي إلى تعميق الفجوة بين الشعب والنظام من جهة، وإلى اهتزاز في هرم السلطة من جهة أخرى.
هذه هي خلاصة الرؤية الغربية – وخصوصاً الأميركية – لوضع طهران بعد الحرب الأخيرة، إذ ترى واشنطن أن إيران فقدت الكثير من الأدوات التي كانت تستخدمها سابقاً في مفاوضاتها لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية.
غير أن حدثين مهمين أظهرا أن التناغم بين واشنطن وأوروبا وإسرائيل ليس كاملاً كما يبدو.
الحدث الأول تمثّل في “الحرب المحدودة” التي جرت رغم شدتها العالية، وردّ إيران العسكري على كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
إن تقبّل واشنطن لردّ عسكري مباشر من طهران على قاعدتها العسكرية الكبرى في قطر كان خطوة غير مسبوقة منذ حرب فيتنام في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وفي المقابل، لم تكن إسرائيل تتصور أن دولة في الشرق الأوسط يمكن أن تستهدف مركز سلطتها بالصواريخ بعد آخر الحروب العربية – الإسرائيلية.
هذا التطور عكس حقيقة لافتة: أن واشنطن باتت تعترف عملياً بقدرة طهران العسكرية وتسعى إلى إدارة علاقة تفاعلية معها حتى في لحظات المواجهة.
أما الحدث الثاني، فهو أن الولايات المتحدة، من خلال اعتمادها سياسة الحرب المحدودة، لم تكن تسعى إلى إسقاط النظام السياسي في إيران، بل إلى التأثير في سياساته ودفعه نحو القبول بشروط تفاوضية محددة.
وقد تجلى ذلك في إعلان وقف إطلاق النار عقب الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، حيث حاولت واشنطن بعدها إقناع طهران بقبول مطالبها.
المغزى الحقيقي من هذه الحرب المحدودة، وفق تحليلات، هو إجبار إيران على القبول بتسوية شاملة بدلاً من مواجهة شاملة.
وهذا التوجه يختلف عن الموقف الإسرائيلي، الذي يسعى إلى استمرار الحرب وتصعيدها، بينما تحاول واشنطن الحفاظ على زمام المبادرة في مواجهة طهران، مع إبقاء أوروبا في موقع ثانوي، رغم أن الترويكا الأوروبية تدّعي دوراً فاعلاً في هذا المجال.
المشهد الراهن يضع أمام طهران تهديدات وفرصاً في آن واحد. فالتهديد يتمثل في أن التحالف الثلاثي بين واشنطن والترويكا الأوروبية وتل أبيب يعتمد على نموذج يقوم على الغموض والضغط والتهديد، وهدفه النهائي إجبار طهران على الخضوع حتى حافة المواجهة الشاملة.
أما الفرصة، فتكمن في أن هذا التحالف لا يقوم بالضرورة على أهداف استراتيجية موحدة، وهو ما يمكن أن تستفيد منه طهران لصياغة موقف مرن ومفتوح يتيح لها هامشاً للمناورة.
ويبقى السؤال: هل ستنجح طهران في تحويل هذه التناقضات إلى فرصة استراتيجية تُمكّنها من إعادة صياغة موقعها في المعادلة الجديدة؟


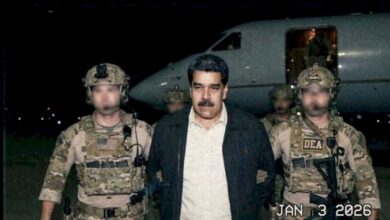



l0tx3l
kcf21a