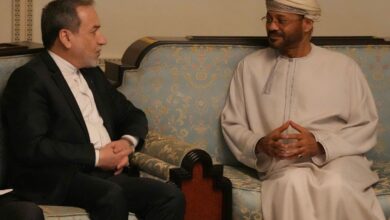بقلم: المعمارية الاستشارية لونا أحمد لؤي رجب – خبيرة وطنية سورية ودولية في مجال التراث الثقافي وإعادة الإعمار
لم يعد التراث الثقافي في عالم اليوم يُنظر إليه بوصفه سجلًا صامتًا للماضي أو مادة للحنين، بل بات يُعد أحد المكونات الأساسية لأي مشروع تنموي مستدام، وعنصرًا حيويًا في بناء المجتمعات وتعزيز تماسكها وهويتها.
وفي الحالة السورية، تتضاعف أهمية هذا الدور، نظراً لما تختزنه البلاد من إرث حضاري استثنائي شكّل، عبر آلاف السنين، إحدى ركائز التاريخ الإنساني.
التراث الثقافي، المادي منه وغير المادي، هو الوعاء الذي انتقلت عبره القيم والمعارف والتجارب الإنسانية من جيل إلى آخر.

وهو لا يقتصر على الآثار المعمارية والمواقع التاريخية، بل يشمل أنماط العيش، والحرف التقليدية، والطقوس الاجتماعية، واللغة، والموسيقى، والموروث الشفهي، وكل ما يعكس العلاقة العميقة بين الإنسان وبيئته.
من هذا المنطلق، فإن التعامل مع التراث بوصفه مورداً ثقافياً فقط يُعد اختزالاً لدوره الحقيقي، إذ إن قيمته تمتد لتشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
تؤكد الدراسات الحديثة، ومنها البحث الذي أنجزناه حول التراث الثقافي والتنمية المستدامة في سورية، أن إدماج التراث في سياسات التنمية يساهم في تحقيق توازن حقيقي بين متطلبات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.
فالتراث، حين يُدار بطريقة علمية ومدروسة، يتحول إلى أداة فاعلة في خلق فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز السياحة الثقافية، وتحفيز الصناعات الإبداعية، دون الإضرار بالقيم الثقافية أو استنزاف الموارد.

في السياق السوري، لا يمكن فصل التراث عن مسألة الهوية الوطنية. فقد أثبتت التجربة أن السوريين، رغم كل ما مرّوا به، ظلوا مرتبطين بتراثهم بوصفه مرجعاً جامعاً وذاكرة مشتركة.
ومن هنا، فإن صون التراث وإعادة تأهيله ليسا مجرد مسألة تقنية أو ثقافية، بل هما جزء من عملية التعافي الوطني وإعادة بناء العلاقة بين الإنسان والمكان.
إن الانتقال بالتراث من خانة “الموروث” إلى خانة “المورد التنموي” يتطلب رؤية وطنية شاملة، تتكامل فيها الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص. فالتنمية المستدامة لا تتحقق من دون احترام الخصوصية الثقافية، ولا يمكن للتراث أن يبقى حيًا من دون أن يكون جزءًا من حياة الناس اليومية ومستقبلهم.